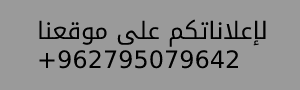هكذا تشكّلت -على حد وصف “الغد”- “جبهة مضادة” لمشروع قانون ضريبة الدخل، تضم النقابات المهنية والأحزاب السياسية، ويمكن أن نضيف إليهما شريحة اجتماعية واسعة، وخبراء اقتصاديين ورجال أعمال، جميعهم لا يكتفون بالمعارضة السلبية، بل الفاعلة للتعديلات الجديدة، مما سيؤثّر -بالضرورة- على المناقشات النيابية للمشروع في الدورة الاستثنائية المرتقبة، بعد عيد الفطر.
دعونا من النقاش في جوهر المشروع ووجهات النظر المختلفة (ناقشنا ذلك في مقالات سابقة)، لنفكّر في مشكلة أصبحت بمثابة “المرض العضال” في السياسة الأردنية وتتمثّل في “الرسالة الاتصالية” وقدرة الدولة على الإعداد والتحضير الجيّد لقوانينها وسياساتها وقراراتها وإقناع النخب والرأي العام بها، فمن الواضح أنّنا خلال الأعوام الأخيرة نعاني من أزمة ثقة عالية بين الحكومات والشارع، تخلق “فجوة” كبيرة تجعل الرواية الرسمية ضعيفة وغير مقبولة!
دعونا نأخذ مشروع القانون الحالي كمثال واضح، فالحكومة أعدّت تصوّراً لا بأس به لاستراتيجية الدفاع عن المشروع وتمريره شعبياً وإعلامياً، واطّلعت على بعض المواد الإعلامية التي تمّ نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحظيت بمشاهدة مئات الآلاف من المواطنين، بحسب التقديرات الرسمية، وهي مواد سهلة سلسة، بلغة محترفة، على الأغلب شاركت “جهات استشارية متخصصة” فيها.
لكن اطّلاع المواطنين على الرسائل الرسمية لا يعني نجاحها أو اقتناع الناس بها، فهذا ما يستطيع وزير الإعلام القيام به، كمسؤولية مباشرة له. لكن الحكومة كانت معنية بأن توسّع قاعدة النقاشات والحوارات مع القوى والمجتمع المدني في مرحلة إعداد المشروع، وأن تضمن قاعدة قوية تدافع عنه، في مواجهة التهرب الضريبي وتأكيد مبدأ العدالة الضريبية، حتى وإن كان ذلك لا يروق لرجال الأعمال والمتهربين ضريبياً، كما يرى مسؤولون، فإنّ الحكومة لم تستطع -كذلك- كسب ودّ الأحزاب السياسية والمعارضة والمجتمع المدني، لأنّها لم تحضّر جيّداً ولم تشرك الآخرين في عملية صنع السياسات الجديدة!
وهذا هو لبّ الموضوع أو الآفة الحالية في الأردن، من غير الممكن الاستمرار بهذا المنطق في تجاهل وجود قوى وديناميكيات سياسية واجتماعية وقوى وأحزاب ونخب كبيرة لها تأثير كبير في النظام السياسي، بصورته الكلية، أو الاكتفاء بالركون إلى “أزمة الثقة” للقول: مهما فعلنا فلن نرضي الشارع، فهذا عنوان فشل ذريع، وعلى المسؤول الذي يردد مثل هذه العبارات أن يعود إلى منزله، أفضل له ولنا جميعاً، مهما كان عبقرياً أو ملمّاً في موضوعه، فهو في النهاية مسؤول سياسي (ضعوا تحتها خطين عريضين)، من واجبه أن يتفاعل مع القوى المختلفة والشارع، وعليه أن يكون مقنعاً ومؤثراً، وأن يتخلّى عن المنطق الذي أصبح يحكم الوزراء اليوم “سكّن تسلم”، لأنّه ليس مسؤولاً في شركة عائلية أو خاصة، بل هو وزير في حكومة لدولة فيها شعب وقوى سياسية!
ما يواجهه المشروع الجديد من تعرقل ومعارضة شرسة أمر طبيعي لتخاذل الوزراء والمسؤولين عن القيام بالمهمة الحقيقية بالتشاور والحوار مع القوى المختلفة، والتحضير لهذه المعركة المهمة.
الغريب أنّ طلاب العلوم السياسية منذ السنة الأولى في البكالوريوس، يدرسون مواد النظم السياسية، والمقاربات المنهاجية الرئيسة (101) سياسة، تحتوي على منهج النظم السياسية، سواء لديفيد أيستون أو تطويراته لجبرائيل ألموند، التي تتحدث عن المدخلات (المطالب والدعم) والمخرجات، والبيئة السياسية المحيطة، والتغذية العكسية، وكارل دويتش الذي كتب قبل عشرات السنين عن أهمية المعلومات والاتصال، أو يدرسون مقترب الجماعات ودوره في تفسير القرارات والصراع المرتبط بها. في ضوء ما نراه لو كان هنالك من يعطي الوزراء درساً في هذه البديهيات السياسية!
د. محمد ابو رمان